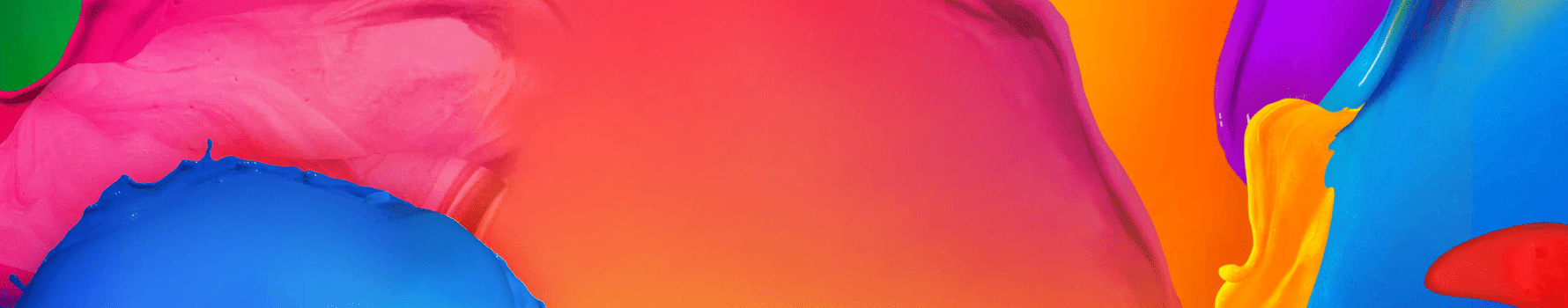إن التأويل راسخ في جذور المعرفة الإنسانية سواء كانت علمية أو عامية، إنه يرتبط بعمليات الإدراك والفهم، أي إنه مرتبط بعلاقة الذات العارفة بموضوع المعرفة. ولَمَّا كان عالم الإنسان كونا من العلامات والرموز، فإنه لن يصبح موضوعا للإدراك والمعرفة، إلا إذا أصبح موضوعا وآلية للتواصل بين الأفراد والمجتمعات. وبهذا كان التأويل نتاجا للثقافة وآلية لإنتاجها في نفس الآن. إنه يمثل الترجمة الرمزية للوجود الواقعي من جهة، وهو يمثل من جهة ثانية، الانتقال من الوجود الرمزي للموضوعات المستقلة عن الذات، إلى وجود تعيد فيه الذات بناء الموضوعات المستقلة، على نحو تصبح معه هذه الموضوعات دالة وذات معنى.
إن التأويل ممارسة يتوقف عليها بناء المعرفة الإنسانية، إذ لا تخلو منها أي ثقافة ولا ينفلت من أسرها أي تفكير، ذلك أن بناء المعرفة وإنتاج الثقافة وممارسة التفكير، كلها تقوم على التواصل، تواصل الذات مع الآخر، وتواصلها مع العالم بأشيائه ووقائعه. ولَمَّا كان التواصل يطرد على طريقة التكسير في التسنين أو التجاوز في التدليل، فقد لزم التأويل كآلية لإقامة هذا التواصل وإتمامه، وبالتالي لبناء المعرفة وتحصيلها.
وهكذا، فإن التأويل ليس ظاهرة مستحدثة في تاريخ المعرفة الإنسانية، إنما هو يمتد إلى زمن أرسطو القائل بأن في كل كلام تأويلا، ذلك أن اللغة تمثل تحريفا للأشياء والوقائع. وهو راسخ على مر مراحل تجربة التفكير الإنساني، فقد مورس التأويل في الثقافة الإغريقية على نهج التقليد الأرسطي، بالمنطق القائم على وحدانية المعنى، إذ مهما تعددت الأعراض واختلفت، يبقى موضوع المعرفة ذا ماهية وجوهر وحقيقة ثابتة. ومورس التأويل على نهج ما عُرف بعلم تفسير النصوص المقدسة، حيث النص المقدس يمثل موضوع المعرفة، ويمثل مستودع الحقيقة المفروض أنها معطاة فيه سلفا من قبل ذات متعالية.
هذا، ليُمارَس التأويل على نهج العلوم الإنسانية، هذه التي شرعت تبحث عن القواعد والقوانين والعلاقات والمعاني والدلالات الكامنة وراء ما يعيشه الناس، لتظهر الهرمينوطيقا كتتويج لتجربة البحث عن المعنى والحقيقة. لقد وعى الفلاسفة بعمق دور الذات المحققة لفعل التأويل في إنشاء المعرفة، هذا الإنشاء الذي يأخذ شكل تأويل لا يمكن فصله عن الإنسان الذي تحمل مسؤولية إحداثه. إن المعرفة إذن ناتجة عن التأويل، والتأويل لا يخلو من ذاتية المؤول التي تضفي طابع النسبية على حاصل المعرفة. وهكذا أخذ الفيلسوف يعترف أنه ليس له إلا تأويله الخاص، وأن معرفته نسبية، ولا خسارة في ذلك عنده في عصر أصبحت فيه حتى الحقائق العلمية تقدم نفسها على أنها حقائق نسبية ووقتية تابعة لشروط التجربة التي أفرزتها.
وبعد هذا، وبعد ما كانت مهمة التفسير الديني تكمن في البرهنة على ما هو مبرهن عليه سلفا، لم يعد ينبغي التساؤل حول ما إنْ كان النص يقول الحقيقة أم لا، بل حول ماذا يقول هذا النص بالضبط؟ وما معنى هذا النص بالضبط؟ وهكذا أصبح الحديث عن التأويل يعني أن نفترض مسبقا أن قراءةً واحدة لا تكفي لفهم المعنى، وأنه يجب أن يكون المعنى متعددا لكي يفوق قدر القراءة الأحادية، ويكون التأويل مرتبطا بالتساؤل عن معنى المعنى، ويكون عبورا من المعنى الظاهر الذي غالبا ما يكون متناقضا، إلى معناه الخفي الذي يُفترض أنه المقصود.
لقد كان التأويل مقصورا في البدايات على تأويل النصوص المقدسة، لكن مجاله اتسع خلال القرن التاسع عشر ليشمل شكل التأويل النصي على نحو أشمل. ثم إن أحدث تطور عُرف في هذا المجال تجسد فيما راكمته الأبحاث اللسانية والسميائية ونظريات التلقي، هذه التي دشنت مشاريع نظرية ومنهجية تهتم بفعل القراءة ومشكلات التلقي والتأويل.
هذا، ومع شساعة التنظير وتطور البحث، لم يعد التأويل مقصورا على نوع بعينه من أنواع الخطاب، بل أصبح يمثل الاستراتيجية التي تمتد إلى مختلف ضروب الأفعال والسلوكات الإنسانية التواصلية، وعلى رأسها التواصل اللغوي، سواء كان إبداعيا فنيا أو عاديا يوميا، ما دام ينطوي على درجة من الالتباس والغموض، وما دام الالتباس يمثل الخاصية الجوهرية للغات الطبيعية، ويمثل الركيزة الأساسية لكل تأويل.